في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة الحياة وتتزايد فيه الضغوط، يزحف إلى بيوتنا خطر هادئ لا ننتبه له إلا بعد فوات الأوان، إنه التفكك الأسري. ذلك الخطر الصامت الذي يبدأ بخلاف بسيط أو كلمة قاسية، ثم يتطور تدريجيًا حتى تتحول المودة إلى جفاء، والحوار إلى صمت، والبيت الدافئ إلى جدران باردة تخلو من الأمان والدفء. إنّ التفكك الأسري لا يعلن عن نفسه بصوتٍ عالٍ، لكنه يترك وراءه جراحًا عميقة في قلوب الأزواج والأبناء، ويهدد نسيج المجتمع بأكمله.
التفكك الأسري لا يحدث فجأة، بل هو نتيجة تراكمات من الإهمال وسوء التواصل وفقدان الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة. حين يغيب الحوار، وتتحول المشاعر إلى صراعات، يبدأ الانفصال النفسي قبل أن يحدث الانفصال الحقيقي. ويزداد الأمر سوءًا مع الانشغال المفرط بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت كل فرد يعيش في عالمه الخاص، بعيدًا عن أسرته ومشاعر من حوله.
إنّ الأبناء هم الضحية الأولى لهذا التفكك، فهم يفقدون الإحساس بالأمان والاستقرار، ويعيشون في دوامة من القلق والاضطراب. تتأثر شخصياتهم وثقتهم بأنفسهم، فيميل بعضهم إلى العزلة أو التمرد أو حتى العنف. وقد يفقدون القدرة على تكوين علاقات صحية في المستقبل، لأنهم لم يعرفوا في طفولتهم معنى الأسرة المتماسكة أو الحب غير المشروط.
أما المجتمع، فإنه يدفع الثمن الأكبر، إذ تتزايد المشكلات الاجتماعية مثل العنف، والانحراف، والتسرب من التعليم. فكل طفل فقد الدفء داخل بيته يصبح مشروع إنسانٍ مضطرب يبحث عن تعويضٍ خارجي قد يكون مؤذيًا له ولمجتمعه. ولهذا فإن حماية الأسرة ليست مسألة شخصية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية وإنسانية.
وللحد من هذا الخطر الصامت، علينا أن نعيد النظر في مفهوم الأسرة، وأن نغرس في بيوتنا قيم الرحمة والتفاهم والتسامح. فالحوار الصادق يمكنه أن يُنهي خلافًا، والاحترام المتبادل يمكنه أن يُعيد الدفء المفقود. كما يجب أن نُولي الأبناء اهتمامًا خاصًا، فهم مرآة ما نزرعه داخل البيت، إن زرعنا حبًا حصدنا استقرارًا، وإن زرعنا تجاهلًا جَنينا ألمًا لا يُشفى.
إنّ الأسرة المتماسكة ليست مجرد حلم، بل هي مسؤولية تبدأ من كل فرد. فحين يُدرك كل أبٍ وأمٍّ أن بيتهما هو نواة المجتمع، وأن الحفاظ عليه يعني الحفاظ على المستقبل، عندها فقط يمكننا مواجهة هذا الخطر الصامت بثقة وأمل.
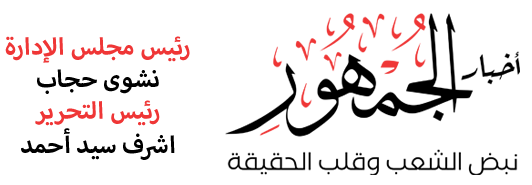 أخبار الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
أخبار الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة

