
لم تعد المزاعم المثارة حول الحضارة المصرية القديمة مجرد «اجتهادات مبالغ فيها» أو آراء هامشية، بل تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى خطاب منظّم يسعى إلى تقويض المعرفة العلمية وتوجيه الوعي العام نحو سرديات ملفّقة تفتقر إلى أي سند علمي. ويتصدّر هذه الموجة عدد من المتحدثين الذين يقدّمون أنفسهم بوصفهم «مكتشفين» لحقائق مذهلة، من قبيل إرجاع عمر الحضارة المصرية إلى 39 ألف سنة، وادعاء وصول المصريين القدماء إلى القارة الأمريكية قبل كولومبوس بثلاثة آلاف عام، أو الزعم بوجود «طاقة الهرم» أو تدخل كائنات فضائية في تشييده، فضلًا عن الحديث عن وجود «وادي الملوك الأول».
هذه الطروحات لا تمثّل أخطاء معرفية عابرة، بل تشكّل تشويهًا مباشرًا للتاريخ المصري القديم، وتقليلًا صارخًا من شأن علم المصريات، الذي تأسّس على جهد تراكمي دقيق امتدّ لأكثر من قرن ونصف، وأسهم فيه آلاف الباحثين من مختلف المدارس العلمية. ولا يقتصر الخطر الحقيقي في هذه الادعاءات على ابتعادها عن الحقيقة، بل يتجسّد في سعيها إلى استبدال التفسير العلمي القائم على الأدلة المادية والبحث الأكاديمي المنهجي بخطاب ميثولوجي مفبرك، وهو ما يفضي إلى تشويه الوعي العام، وتقويض الثقة في أحد أهم فروع العلوم الإنسانية، وهو علم المصريات.
من هنا تأتي أهمية هذا المقال، الذي يهدف إلى تفنيد هذه المزاعم تفنيدًا منهجيًا، استنادًا إلى الدليل المادي الصلب، وإلى ما أكدته الدراسات الأثرية والأنثروبولوجية والجينية الحديثة، والتي رسمت إطارًا زمنيًا واضحًا لتطوّر الحضارة المصرية منذ نشأة المجتمعات الزراعية الأولى وحتى قيام الدولة المركزية.
يعمد مروّجو فكرة إطالة عمر الحضارة المصرية إلى عشرات الآلاف من السنين إلى اقتطاع نصوص قديمة من سياقها، ثم ليّ أعناقها لتتلاءم مع تصوراتهم المسبقة. وغالبًا ما يستندون إلى تفسيرات أسطورية لأجزاء من بردية تورين، أو إلى قوائم «الملوك الأجلاء» التي نقلها المؤرخ مانيتون. غير أن هذه الاستشهادات تفتقر إلى أي قيمة تأريخية علمية، وتتعارض بوضوح مع المنهج التاريخي المعتمد دوليًا، والذي يقوم على الأدلة المادية المباشرة، مثل الطبقات الحضارية، والمقابر، والنقوش، والفخار، والتحليل الكربوني، والدراسات الجينية والأنثروبولوجية.
فبردية تورين، على سبيل المثال، تضم قسمين مميزين: جزءًا أسطوريًا يتناول الآلهة وأنصاف الآلهة، وجزءًا تاريخيًا يذكر ملوكًا موثّقين أثريًا. أما مانيتون، فقد جمع روايات متعددة المصادر، تراوحت بين السجلات الرسمية والأساطير والتقاليد الشفوية، وصاغ منها سردًا تاريخيًا يتلاءم مع يتلاءم مع البيئة الثقافية الإغريقية، دون أن يكون هدفه وضع تقويم زمني دقيق بالمعنى العلمي الحديث.
ومن المهم التأكيد على أن النصوص الأسطورية — سواء في مصر أو في حضارات أخرى مثل السومرية أو اليونانية — تحمل قيمة رمزية ودينية وثقافية، لكنها لا تصلح أساسًا للتأريخ الواقعي. وأي محاولة لاستغلال هذه النصوص لإطالة عمر الحضارة المصرية تتجاهل الطبيعة الرمزية للأسطورة، وتتناقض مع الكمّ الهائل من الأدلة المادية المتراكمة.
ولا تقف الإشكالية عند حدود سوء قراءة المصادر، بل تتعداها إلى تجاهل السجل الأثري، الذي يمثّل العمود الفقري للتأريخ العلمي. فالدراسات الطبقية في مواقع مثل نقادة، والفيوم، ومرمدة بني سلامة، تكشف تسلسلًا واضحًا لتطور المجتمعات القروية والزراعية منذ نحو 5500 ق.م، مع ظهور تدريجي للفخار المميز، والعمارة الطينية، وأنماط الدفن، ثم بروز ثقافتي نقادة الثانية والثالثة، اللتين مهّدتا مباشرة لتوحيد البلاد.
وتؤكد تحليلات الكربون المشع، التي أُجريت على مئات العينات العضوية، أن توحيد مصر العليا والسفلى تمّ حوالي 3100 ق.م، مع ظهور الملك نعرمر (مينا)، الذي يمثّل نقطة البداية المعتمدة للتاريخ المصري الموثّق، حيث ظهرت الكتابة، والنظام الإداري، والدين المؤسسي.
وتعزّز دراسات الجينات القديمة هذه النتائج، ولا سيما تلك المُجراة على مومياوات عصري الدولة الوسطى والدولة الحديثة، إذ تُظهر توافقًا زمنيًا وثقافيًا دقيقًا مع المعطيات الأثرية. ويؤكد التسلسل الجيني مسارًا سكانيًا متدرجًا تطوّر على مدى آلاف السنين، دون أي مؤشرات على انقطاعات أو طفرات استثنائية يمكن أن تبرّر افتراض وجود حضارة مجهولة تعود إلى عشرات الآلاف من السنين.
أما الادعاء بوصول المصريين القدماء إلى القارة الأمريكية، فيمثّل مثالًا صارخًا على صناعة الوهم. فلا يوجد أي دليل أثري أو نصي موثوق يربط مصر القديمة بالعالم الجديد قبل القرن الخامس عشر الميلادي؛ فلا موانئ مصرية على الأطلسي، ولا آثار لسفن عابرة للمحيطات، ولا نقوش تصف رحلات إلى الغرب، ولا شواهد على تبادل تجاري عبر المحيط. وهو ادعاء لا يفتقر فقط إلى الأساس العلمي، بل يسيء إلى عقل القارئ ذاته.
وينطبق الأمر نفسه على مزاعم «طاقة الهرم» أو «الفضائيين البنّائين». فهذه الأفكار تقوم على تكهنات غير علمية، وتتجاهل ما أثبتته الدراسات الهندسية والمعمارية الحديثة، التي أوضحت أن المصريين القدماء امتلكوا معرفة متقدمة بالهندسة والقياس والتنظيم، واستخدموا أدوات حجرية وخشبية وتقنيات بناء متقنة، مكّنتهم من تشييد الأهرام دون الحاجة إلى فرضيات خارقة للطبيعة. كما أن آلاف النقوش الموثّقة للعمال والمهندسين، وعشرات المحاجر القائمة حتى اليوم، تجعل هذه المزاعم أقرب إلى الخيال الشعبي منها إلى أي معرفة علمية رصينة.
أما ما يُسمّى بـ«وادي الملوك الأول»، فهو خلط واضح بين الأسطورة والواقع الأثري. فوادي الملوك المعروف يعود إلى عصر الدولة الحديثة (حوالي 1550–1070 ق.م)، ودُفن فيه ملوك الأسرات من الثامنة عشرة إلى العشرين، ولا توجد أي أدلة أثرية أو حفريات علمية تشير إلى وجود وادٍ سابق مماثل.
إن أخطر ما في هذه الطروحات أنها تحوّل حضارة عظيمة — لم تحتج يومًا إلى المبالغات كي تستحق إعجاب العالم — إلى مادة خام لأساطير قائمة على الجهل وسوء الفهم. فالحضارة المصرية أرقى من أن تُختزل في «طاقات خارقة» أو «تأريخ فلكي» أو «اختراعات فوق بشرية». إنجازاتها الحقيقية كافية: إدارة معقدة، عمارة حجرية مذهلة، نظام كتابي فريد، وفكر ديني وفلسفي عميق شكّل وجدان العالم القديم.
الحديث عن «حضارة عمرها 39 ألف سنة» ليس اكتشافًا، بل تضليلًا مكشوفًا. وهو لا يمثّل اجتهادًا قابلًا للنقاش، بل إساءة للتاريخ، وتزييفًا للعلم، وازدراءً صريحًا لعقل القارئ. إن الحضارة المصرية لا تحتاج إلى خرافات كي تبدو عظيمة؛ عظمتها راسخة في الحَجَر والنقش والدليل المادي الذي لا يجامل ولا يكذب. والصمت عن هذه الادعاءات تواطؤ غير مباشر في تشويه الوعي العام. لذلك، فإن مواجهة هذا العبث ليست خيارًا، بل واجب معرفي وأخلاقي. فإما تاريخ يُقرأ بعين العلم، أو أسطورة تُروَّج بعناوين صاخبة… ولا يمكن الجمع بين الاثنين.
بقلم الاستاذ الدكتور/ خالد حمزة
أستاذ الاثار المصرية
وعميد كلية الآداب السابق – جامعة المنوفية
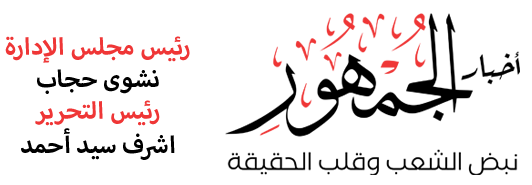 أخبار الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
أخبار الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
